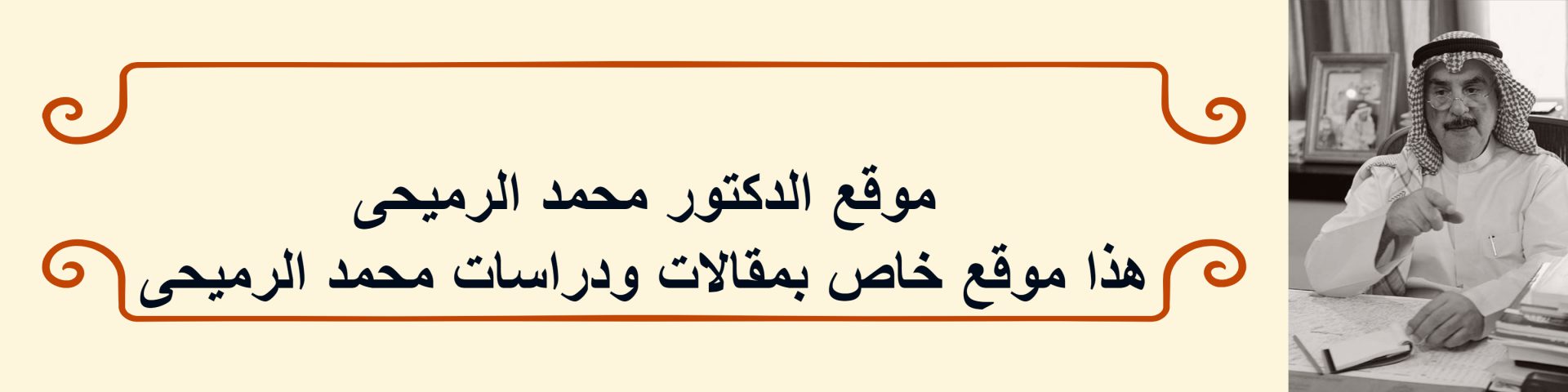بين التنجيم والعقل: لماذا نُصرّ على تصديق ما لا يُفسَّر؟
في نهاية كل عام يتكرر المشهد ذاته تقريبًا، إذ يظهر عشرات الرجال والنساء على الشاشات ليقدموا ما يسمونه قراءة للمستقبل، ويعرضوا على جمهور واسع سلسلة من التوقعات التي تمتد من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الكوارث إلى مصائر الدول والأفراد. بعض هذه التوقعات يصيب مصادفة، وأكثرها يخطئ، غير أن المدهش ليس صحة ما يقال أو خطؤه، بل حجم التصديق والاهتمام، وكأن المجتمعات تبحث عن يقين سهل يعوض عجزها عن فهم واقع معقد ومتشابك.
ليلى عبد اللطيف، بوصفها مثالًا لا شخصًا، تمثل هذا النمط من الخطاب الشائع. فقد قالت في نهاية العام الماضي إن ليبيا ستُحكم من شخصية بعينها، ( سيف الإسلام الغذاقي) ثم جاءت الوقائع لتسير في اتجاه مختلف تمامًا ، فقد قتل الرجل الأسبوع اماضي ، ومع ذلك لم يؤد الخطأ الواضح إلى تراجع الإيمان بالمنظومة نفسها، ولم تُطرح الأسئلة الجوهرية حول منهج التوقع وجدواه وحدوده ومعاييره.
المفارقة أن هذا السلوك يتناقض جذريًا مع منطق العلم. فالعلم يقوم على فرضيات قابلة للاختبار، وعلى بيانات، وعلى قابلية الخطأ والتصحيح. أما التنجيم فيعتمد على إطلاق احتمالات عامة وفضفاضة، ثم اختيار ما يصيب لاحقًا وتضخيمه، مع تجاهل عشرات التوقعات التي لم تتحقق. إنه منطق انتقائي لا معرفي، لكنه يجد قبولًا واسعًا في بيئات يسودها القلق وعدم اليقين.
في العالم العربي تتضاعف هذه القابلية بسبب عوامل متراكمة، من بينها ضعف التخطيط طويل الأمد، وهشاشة المؤسسات، وغياب الشفافية، وشعور الفرد بأنه خارج معادلة التأثير في القرار العام. حين يغيب الإحساس بالقدرة على الفعل، يتحول المستقبل من مجال للتخطيط العقلاني إلى مادة للتكهن، ومن مشروع إنساني قابل للبناء إلى لغز غيبي مغلق.
ولا يمكن إغفال أثر الأزمات المتلاحقة التي عاشتها المنطقة، من حروب وصراعات وانسدادات سياسية، إذ دفعت كثيرين إلى البحث عن تفسير سريع للأحداث، حتى لو كان هذا التفسير وهميًا. فالتنجيم هنا يصبح ملاذًا نفسيًا مؤقتًا أكثر منه أداة معرفة راسخة، ويمنح شعورًا زائفًا بالسيطرة على المجهول.
تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا في ترسيخ هذه الظاهرة. فحين تُقدَّم التوقعات في قوالب جذابة، وتُسوَّق على أنها قراءة عميقة أو تحليل استثنائي، يختلط الترفيه بالمعرفة، ويُمنح الوهم شرعية لا يستحقها. ومع الوقت يصبح المنجّم أكثر حضورًا من الباحث، وأكثر تأثيرًا من الخبير، لأنه يعد باليقين بينما يعترف الآخر بالتعقيد والتعدد والاحتمال.
كما أن الثقافة التعليمية السائدة لا تساعد كثيرًا على مقاومة هذا الميل، إذ نادراً ما يُدرَّب الطالب على الشك المنهجي، أو على مساءلة المعلومة، أو على التمييز بين الرأي والمعرفة. ومع غياب هذا التدريب يصبح العقل مستعدًا لتلقي أي سردية مريحة، حتى لو كانت بلا أساس علمي أو منطقي واضح.
الخروج من دائرة التكهنات لا يكون بمحاربة الأشخاص، بل بتغيير الثقافة العامة. نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعقل النقدي، وتعليم الفرق بين التحليل القائم على معطيات، والتخمين القائم على الحدس، وإعادة الثقة بفكرة أن المستقبل يُبنى ولا يُتنبأ به.
هذه المهمة ليست سهلة ولا سريعة، لكنها ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية، والتعليم الجيد، والإعلام المسؤول، والنقاش العام المفتوح، والمساءلة المجتمعية المستمرة، والوعي الفردي المتنامي الحقيقي الضروري اليوم والآن معًا تمامًا.
المستقبل لا يُقرأ في الأبراج ولا في الشاشات، بل يُصنع بالسياسة الرشيدة، والاقتصاد المنتج، والعلم، والعمل. وكلما أسرعنا في إدراك هذه الحقيقة، اقتربنا خطوة إضافية من الخروج من أسر الوهم إلى أفق الفعل الواعي والمسؤول الجماعي دائمًا.